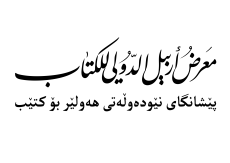أربيل / تبارك عبد المجيد
تخللت جلسات معرض أربيل الدولي للكتاب لحظة مختلفة، حملت معها طيفاً شعرياً وسردا ذاتيا مفعمًا بالتجربة، وذلك خلال جلسة حوارية استثنائية مع الشاعر والكاتب اللبناني عبده وازن، أدارها الشاعر منذر عبد الحر بأسلوب جذاب ومؤثر. حملت عنوان “رحلة في عوالم عبده وازن”.
افتتح عبد الحر اللقاء بكلمات ترحيب تنبض بالعرفان، قائلاً: “الاسم الذي رن في أذهاننا طويلا، وهو يعمل في الصحافة الثقافية في أوج ازدهارها وعطائها، مقدما لونا صعبا وخاصا، ولا سيما في جريدة عريقة كالحياة، وفي عاصمة تشع بالحضارة والثقافة مثل بيروت”.
عبده وازن، المولود في زهو العطاء الأدبي، استطاع أن يشكل بصمة استثنائية في المشهد الثقافي العربي، عبر مسيرة غنية تماوجت فيها ألوان الإبداع، من الشعر إلى الرواية، ومن الترجمة إلى العمل الصحافي، قدم خلال مسيرته تجارب متنوعة وأعمالًا ما زالت تحتفظ بملامحها في وجدان القارئ، لما تحمله من صدق التعبير وعمق الرؤية.
في حديثه خلال الجلسة، استعاد الشاعر والكاتب عبده وازن بداياته الصحافية قائلاً: “أعتبر نفسي محظوظا لأنني بدأت العمل في الصحافة منذ الثمانينيات. بدأت في جريدة الأنوار، ثم انتقلت إلى النهار، التي كانت في ذلك الوقت من أشهر الصحف وأكثرها عمقا في مفهوم الصحافة. كانت الصحافة العربية واللبنانية لا تزال في بداياتها، خاصة على الصعيد الثقافي”.
لم يقتصر وازن في كتاباته على تغطية الأحداث المحلية، بل سعى منذ بدايته إلى الانفتاح على الثقافة العربية بمفهومها الأوسع، مستفيدا من مكانة بيروت التي كانت، ولا تزال، مركزا أساسيا للطباعة والنشر العربي، “الحرب لم تستطع أن تنتزع من بيروت هذا الدور الثقافي الحيوي”، قال وازن بثقة.
وأشار إلى أن تجربته في النقد والترجمة جاءت متقاطعة مع عمله في الصحافة، حيث تمكن من مواكبة حركة النشر العربي، لا سيما أن تخصصه الأكاديمي كان في هذين المجالين. “مارست النقد والترجمة ضمن حدود الصحافة ولم اكتب لاستعراض عضلاتي الثقافية”، واوضح أن للنقد نوعين: النقد الصحفي والنقد الأدبي.
وتوقف عبده وازن خلال الجلسة عند بيروت بوصفها ظاهرة ثقافية استثنائية، قائلًا: “كانت بيروت في الستينيات مختبرا ثقافيا، أدبيا، سياسيا، وفكريا بامتياز، خصوصا بعد أن أطلقت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع العمل الفدائي، الذي أحدث تحولا في الفكر العربي وفي حركة التحرر العربي”. وأشار إلى أن تلك المرحلة اتسمت بقمع المثقفين وملاحقة الرأي في بلدان عدة، ما جعل بيروت ملاذا وفضاء حرا، فاستقطبت عددًا كبيرا من الكتاب والمثقفين العرب.
“بيروت شهدت ولادة مجلة شعر، والتيار الحداثي الذي أطلقته تلك المجلة كان له تأثير بالغ في العالم العربي، وفي الأوساط الأدبية والفكرية تحديدًا”، هكذا وصف وازن الدور الطليعي الذي لعبته العاصمة اللبنانية في تلك المرحلة، ليس فقط على مستوى النشر، بل كمنصة حقيقية لصناعة التحول الثقافي.
وعن انتقاله إلى كتابة الرواية، أوضح وازن أنه جاء من خلفية شعرية راسخة، قائلًا: “قرأت الكثير من الشعر قبل أن أكتب، وكنت أنتمي إلى مدرسة تحصنّا فيها بالقراءة والاطلاع، سواء بالعربية أو الفرنسية”. وأضاف: “أنا ابن القراءة. قرأت كثيرًا قبل أن أكتب، وركزنا في دراستنا على أدب عصر النهضة، وهو ما صقل لغتي وأدواتي”.
ولفت إلى أن دراسته في المدارس الكاثوليكية منحته قدرة مزدوجة في التلقي، لكنه أشار أيضا إلى المفارقة التي عاشها قائلاً: “إن المدارس الكاثوليكية كانت تريد أن نتعمق فيها، لذلك بقيت علاقتي باللغتين — العربية والفرنسية — علاقة تكامل “.
وتابع: “بعد أن نشرت ديواني الأول، وجدت نفسي خارج السياق الشعري السائد آنذاك في بيروت، خصوصا ذلك الشعر الجنوبي، السياسي، المقاوم وغيره. شعرت أن لا علاقة لي بذلك المسار، رغم قراءتي المتعمقة لبدر شاكر السياب وأنسي الحاج وغيرهما”.
لكنه لم ينفِ تأثيرات أخرى كانت تسري في تجربته، قائلاً: “تأثرت ببعض النفحات الصوفية والمدارس الغربية، وبين العربية، التي كانت مدينتي، والفرنسية التي فتحت لي نوافذ مختلفة، استطعت أن أخلق عالمي الخاص”.
عبده وازن لا يرى الشعر محصورا بالهويات أو محاطًا بجدران اللغة، بل يؤمن بأنه خط كوني: “أنا مؤمن أن الشعر لا علاقة له بالهويات أو اللغات، هو كلمات تخاطب العالم. لكن لا يمكن أن نفصل بين الكلمة وبيئتنا، ووعينا الفردي والجماعي”.
وأشار بوضوح إلى استقلاله الشعري: “سلكت طريقاً مختلفاً، دون أن أقطع مع أحد”